العبودية هي الطريق إلى التقدم أو إلى الدمار. "لماذا يأتي الأسوأ إلى السلطة؟"
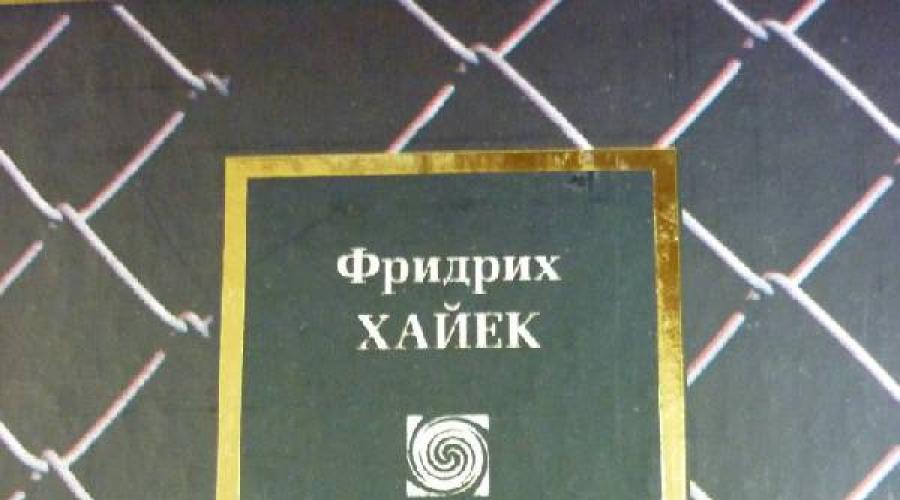
فريدريش أوجست فون هايك
الطريق إلى العبودية
دراسة
© ترجمة م.ب. جيدوفسكي، 1990
[الإصدار الأول: "أسئلة فلسفية"، 1990-1991]
المحرر ت.س. جينسبيرغ
الابن المحرر أ.يا. فيليمونوفا
المراجعين بواسطة A. S. Rogozin
حايك ف. فون، الطريق إلى العبودية: ترانس. من الانجليزية / مقدمة ن.يا. بيتراكوفا. - م: "الاقتصاد"، 1992. - 176 ص.
إيسبن 5--282--01501--3
بنك البحرين والكويت 65.9(4أ)
تم تسليمه للتجنيد بتاريخ 28/03/91. وقع للنشر بتاريخ 04/06/91.
توزيع 10000 نسخة.
دار النشر "الاقتصاد"، 121864، موسكو، G-59، جسر Berezhkovskaya، 6
الاشتراكيون من كل الأحزاب
الحرية مهما كانت مفقودة
عادة تدريجيا.
مقدمة
عندما يكتب عالم الاجتماع كتابا سياسيا، فمن واجبه أن يقول ذلك مباشرة. هذا كتاب سياسي، ولا أريد أن أدعي أنه يدور حول شيء آخر، على الرغم من أنني أستطيع أن أشير إلى نوعه بمصطلح أكثر دقة، على سبيل المثال، مقالة اجتماعية فلسفية. ومع ذلك، مهما كان عنوان الكتاب، فإن كل ما أكتبه فيه ينبع من التزامي بقيم أساسية معينة. ويبدو لي أنني قمت بواجبي الآخر الذي لا يقل أهمية، حيث أوضحت بالكامل في الكتاب نفسه ما هي القيم التي تستند إليها جميع الأحكام الواردة فيه.
ويبقى أن أضيف أنه على الرغم من أن هذا كتاب سياسي، إلا أنني متأكد تمامًا من أن المعتقدات الواردة فيه ليست تعبيرًا عن اهتماماتي الشخصية. لا أرى أي سبب يجعل مجتمعًا من النوع الذي أفضّله على ما يبدو يمنحني أي امتياز على غالبية زملائي المواطنين. وفي الواقع، كما يزعم زملائي الاشتراكيون، فإنني باعتباري خبيراً اقتصادياً سوف أحتل مكاناً أكثر بروزا في المجتمع الذي أعارضه (إذا كان بوسعي بطبيعة الحال أن أتقبل وجهات نظرهم). أنا واثق بنفس القدر من أن اختلافي مع هذه الآراء ليس نتيجة لتربيتي، لأنها هي التي التزمت بها في سن مبكرة وهي التي أجبرتني على تكريس نفسي للدراسات المهنية في الاقتصاد. بالنسبة لأولئك الذين، كما جرت العادة الآن، على استعداد لرؤية دوافع أنانية في أي عرض لموقف سياسي، اسمحوا لي أن أضيف أن لدي كل الأسباب لعدم كتابة هذا الكتاب أو نشره. لا شك أن ذلك "سيؤذي الكثيرين الذين أود أن أظل ودودًا معهم. وبسبب ذلك، اضطررت إلى تنحية الأعمال الأخرى جانبًا، والتي، بشكل عام، أعتبرها أكثر أهمية وأشعر بالاستعداد بشكل أفضل لها. وأخيرًا، سيضر ذلك بالإدراك". نتائج أنشطتي البحثية الخاصة، والتي أشعر بميل حقيقي إليها.
إذا كنت، على الرغم من ذلك، ما زلت أعتبر نشر هذا الكتاب واجبي، فقد كان ذلك فقط بسبب العواقب الغريبة والمحفوفة بالعواقب التي لا يمكن التنبؤ بها للوضع (الذي يصعب ملاحظته لعامة الناس) والذي تطور الآن في المناقشات حول السياسة الاقتصادية المستقبلية. والحقيقة أن أغلب الاقتصاديين انجذبوا مؤخراً إلى التطورات العسكرية وصمتوا بسبب الموقف الرسمي الذي يشغلونه. ونتيجة لذلك، فإن الرأي العام حول هذه القضايا اليوم يتشكل بشكل أساسي من قبل الهواة، أولئك الذين يحبون الصيد في المياه العكرة أو يبيعون علاجًا عالميًا لجميع الأمراض بسعر رخيص. في هذه الظروف، لا يحق لأي شخص لا يزال لديه الوقت للعمل الأدبي أن يحتفظ لنفسه بمخاوف من أن الكثيرين يتشاركون، ولكنهم لا يستطيعون التعبير، مع ملاحظة الاتجاهات الحديثة. وفي ظروف أخرى، أود بكل سرور أن أترك المناقشة حول السياسة الوطنية للأشخاص الأكثر موثوقية ومعرفة في هذا الشأن.
تم تلخيص الأحكام الرئيسية لهذا الكتاب لأول مرة بشكل موجز في مقالة “الحرية والنظام الاقتصادي” التي نُشرت في أبريل 1938 في مجلة Contemporary Review، وفي عام 1939 أعيد طبعها في نسخة موسعة في أحد الكتيبات الاجتماعية والسياسية المنشورة تحت التحرير. بواسطة البروفيسور. ج.د. مطبعة جامعة جيديون في شيكاغو. وأشكر ناشري هذين المنشورين على الإذن بإعادة طبع بعض المقتطفات منهما.
اف ايه حايك
الشيء الأكثر إزعاجًا في هذه الدراسات هو ذلك
التي تكشف أنساب الأفكار.
اللورد أكتون
تختلف الأحداث الحديثة عن الأحداث التاريخية في أننا لا نعرف إلى أين تقودنا. إذا نظرنا إلى الوراء، يمكننا أن نفهم الأحداث الماضية من خلال تتبع وتقييم عواقبها. لكن التاريخ الحالي ليس تاريخا بالنسبة لنا. إنه موجه نحو المجهول، ولا يمكننا أبدًا أن نقول ما ينتظرنا في المستقبل. سيكون كل شيء مختلفًا لو أتيحت لنا الفرصة أن نعيش نفس الأحداث مرة أخرى، وأن نعرف مسبقًا ما ستكون نتيجتها. سننظر بعد ذلك إلى الأشياء بعيون مختلفة تمامًا، وفيما بالكاد نلاحظه الآن، سنرى نذيرًا للتغيرات المستقبلية. وربما يكون من الأفضل أن تكون هذه التجربة مغلقة أمام الإنسان، وأنه لا يعرف القوانين التي تحكم التاريخ.
ومع ذلك، على الرغم من أن التاريخ لا يعيد نفسه حرفيًا، ومن ناحية أخرى، لا يوجد تطور للأحداث أمر لا مفر منه، يمكننا أن نتعلم من الماضي لمنع تكرار بعض العمليات. ليس من الضروري أن تكون نبيًا لتدرك الخطر الوشيك. في بعض الأحيان، يسمح الجمع بين الخبرة والاهتمام لشخص واحد فجأة برؤية الأشياء من زاوية لا يراها الآخرون بعد.
الصفحات التالية هي نتيجة تجربتي الشخصية. الحقيقة هي أنني تمكنت من عيش نفس الفترة مرتين، مرتين على الأقل لألاحظ تطورًا مشابهًا جدًا للأفكار. من غير المرجح أن تكون هذه التجربة متاحة لشخص يعيش طوال الوقت في بلد واحد، ولكن إذا كنت تعيش لفترة طويلة في بلدان مختلفة، فإنه في ظل ظروف معينة يتبين أنه يمكن تحقيقه. والحقيقة هي أن تفكير معظم الأمم المتحضرة يخضع أساسًا لنفس التأثيرات، لكنها تظهر في أوقات مختلفة وبسرعات مختلفة. ولذلك، عند الانتقال من بلد إلى آخر، يمكنك أحيانًا أن تشهد نفس المرحلة من التطور الفكري مرتين. وفي نفس الوقت تتكثف المشاعر بطريقة غريبة. عندما تسمع للمرة الثانية آراء أو نداءات سمعتها بالفعل منذ عشرين أو خمسة وعشرين عامًا، فإنها تكتسب معنى ثانيًا، ويُنظر إليها على أنها أعراض لميل معين، كعلامات تشير، إن لم تكن الحتمية، فعلى الأقل الاحتمال. من نفس الشيء لأول مرة، التطورات.
ربما حان الوقت لقول الحقيقة، مهما بدت مريرة: إن الدولة التي نخاطر بتكرار مصيرها هي ألمانيا. صحيح أن الخطر لم يقترب بعد، والوضع في إنجلترا والولايات المتحدة لا يزال بعيدًا تمامًا عما رأيناه في السنوات الأخيرة في ألمانيا. ولكن على الرغم من أنه لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه، يجب أن ندرك أنه مع كل خطوة، ستكون العودة إلى الوراء أكثر صعوبة. وإذا كنا، إلى حد كبير، أسياد مصيرنا، فإننا في موقف معين نعمل كرهائن للأفكار التي أنشأناها بأنفسنا. ولن نتمكن من التغلب عليه إلا من خلال إدراك الخطر في الوقت المناسب.
إن إنجلترا والولايات المتحدة الحديثة ليستا مثل ألمانيا هتلر كما عرفناها خلال هذه الحرب. ولكن من غير المرجح أن يتجاهل أي شخص يبدأ في دراسة تاريخ الفكر الاجتماعي التشابه السطحي بأي حال من الأحوال بين تطور الأفكار الذي حدث في ألمانيا أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدها، والاتجاهات الحالية التي انتشرت في البلدان الديمقراطية. وهنا اليوم ينضج نفس التصميم على الحفاظ على الهياكل التنظيمية التي تم إنشاؤها في البلاد لأغراض دفاعية من أجل استخدامها لاحقًا في الإبداع السلمي. ويتطور هنا نفس الازدراء لليبرالية القرن التاسع عشر، ونفس "الواقعية" المنافقة، ونفس الاستعداد القدري لقبول "الاتجاهات الحتمية". وما لا يقل عن تسعة من كل عشرة دروس يحثنا الإصلاحيون الصاخبون على تعلمها من هذه الحرب هي بالضبط نفس الدروس التي تعلمها الألمان من الحرب الأخيرة والتي منها تم إنشاء النظام النازي. ستتاح لنا الفرصة أكثر من مرة في هذا الكتاب للتأكد من أننا نسير على خطى ألمانيا في العديد من النواحي الأخرى، متخلفة عنها بمقدار خمسة عشر إلى خمسة وعشرين عامًا. لا يحب الناس أن يتذكروا ذلك، ولكن لم يمر الكثير منذ أن نظر التقدميون إلى السياسات الاشتراكية في ألمانيا كمثال يحتذى به، تمامًا كما كانت كل أعين التقدميين في الآونة الأخيرة مركزة على السويد. وإذا تعمقنا في الماضي، فلا يسعنا إلا أن نتذكر مدى عمق تأثير السياسة والأيديولوجية الألمانية على المثل العليا لجيل كامل من البريطانيين والأمريكيين جزئيا عشية الحرب العالمية الأولى.
قضى المؤلف أكثر من نصف حياته البالغة في وطنه النمسا، على اتصال وثيق بالبيئة الفكرية الألمانية، والنصف الثاني في الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا. خلال هذه الفترة الثانية، تزايدت لديه القناعة باستمرار بأن القوى التي دمرت الحرية في ألمانيا كانت تعمل هنا أيضًا، جزئيًا على الأقل، وكانت طبيعة ومصادر الخطر أقل فهمًا هنا مما كانت عليه في وقتهم في ألمانيا. وهنا لم يروا بعد المأساة التي وقعت في ألمانيا، حيث فتح أصحاب النوايا الطيبة، الذين يعتبرون نموذجاً ويثير الإعجاب في البلدان الديمقراطية، الطريق أمام قوى تجسد الآن كل ما نكرهه أكثر من أي شيء آخر. إن فرصنا في تجنب مثل هذا المصير تعتمد على رصانتنا، وعلى استعدادنا للتشكيك في الآمال والتطلعات التي نزرعها اليوم ورفضها إذا كانت تحتوي على خطر. وفي غضون ذلك، يشير كل شيء إلى أننا نفتقر إلى الشجاعة الفكرية اللازمة للاعتراف بأخطائنا. وما زلنا لا نريد أن نرى أن صعود الفاشية والنازية لم يكن رد فعل على الاتجاهات الاشتراكية في الفترة السابقة، بل كان استمرارًا وتطورًا حتميًا لهذه الاتجاهات. ولا يريد كثيرون الاعتراف بهذه الحقيقة حتى بعد أن أصبحت أوجه التشابه بين أسوأ تجليات النظام في روسيا الشيوعية وألمانيا الفاشية أكثر وضوحا. ونتيجة لذلك، فإن الكثيرين، الذين يرفضون النازية كأيديولوجية ولا يقبلون بصدق أيًا من مظاهرها، يسترشدون في أنشطتهم بالمثل العليا التي يفتح تنفيذها طريقًا مباشرًا إلى الاستبداد الذي يكرهونه.
إن أي تشابه بين مسارات التنمية في مختلف البلدان هو بطبيعة الحال خادع. لكن حججي لا تستند فقط إلى مثل هذه التشابهات. كما أنني لا أصر على حتمية هذا المسار أو ذاك. (إذا كانت الأمور قاتلة إلى هذا الحد، فلن يكون هناك أي معنى لكتابة كل هذا). وأنا أزعم أن بعض الميول يمكن كبح جماحها إذا جعلنا الناس يفهمون في الوقت المناسب أين يتم توجيه جهودهم حقا. ولكن حتى وقت قريب، كان هناك أمل ضئيل في أن يتم الاستماع إليهم. الآن، في رأيي، حان الوقت لإجراء مناقشة جادة لهذه المشكلة برمتها. ولا يقتصر الأمر على أن المزيد والمزيد من الناس يدركون خطورتها اليوم؛ هناك أيضًا أسباب إضافية تجبرنا على مواجهة الحقيقة.
قد يقول البعض إن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لطرح موضوع يسبب مثل هذا التصادم الحاد في الآراء. لكن الاشتراكية التي نتحدث عنها هنا ليست قضية حزبية، وما نناقشه لا علاقة له بالمناقشات التي تدور بين الأحزاب السياسية.* أن بعض المجموعات تريد المزيد من الاشتراكية والبعض الآخر أقل، وأن البعض يدعو إليها على أساس على مصالح جزء من المجتمع والآخرين - جزء آخر - كل هذا لا يمس جوهر الأمر. لقد حدث أن الأشخاص الذين لديهم الفرصة للتأثير على مسار تنمية البلاد هم جميعًا اشتراكيون بدرجة أو بأخرى. ولهذا السبب أصبح من غير المألوف التأكيد على التمسك بالقناعات الاشتراكية، لأن هذه الحقيقة أصبحت عالمية وواضحة. لا يكاد أحد يشك في أننا يجب أن نتحرك نحو الاشتراكية، وكل الخلافات تتعلق فقط بتفاصيل مثل هذه الحركة، وضرورة مراعاة مصالح مجموعات معينة.
إننا نسير في هذا الاتجاه لأن هذه هي إرادة الأغلبية، وهذا هو الشعور السائد. لكن لم تكن هناك، ولا توجد، عوامل موضوعية تجعل التحرك نحو الاشتراكية أمرًا لا مفر منه. (سنتطرق أدناه إلى أسطورة "حتمية" التخطيط). والسؤال الرئيسي هو إلى أين ستقودنا هذه الحركة. وإذا بدأ الأشخاص الذين تشكل قناعتهم عماد هذه الحركة، يتقاسمون الشكوك التي تعبر عنها الأقلية اليوم، أفلا يتراجعون في رعب عن الحلم الذي يحير العقول منذ نصف قرن، أفلا يتخلون عنه؟ إلى أين ستأخذنا أحلام جيلنا بأكمله؟ هذا سؤال يجب أن يقرره ليس أي طرف بعينه، بل كل واحد منا. هل يمكن للمرء أن يتخيل مأساة كبيرة إذا، بينما نحاول حل مسألة المستقبل بوعي والتركيز على المُثُل العليا، نخلق عن غير قصد في الواقع العكس التام لما نسعى إليه؟
هناك سبب ملح آخر يدفعنا اليوم إلى التفكير بجدية في القوى التي أدت إلى نشوء الاشتراكية القومية. بهذه الطريقة يمكننا أن نفهم بشكل أفضل نوع العدو الذي نقاتل ضده. ليست هناك حاجة لإثبات أننا مازلنا لا نعرف جيداً ما هي المُثُل الإيجابية التي ندافع عنها في هذه الحرب. نحن نعلم أننا ندافع عن حرية تشكيل حياتنا وفقًا لأفكارنا الخاصة. وهذا كثير، ولكن ليس كل شيء. وهذا لا يكفي للحفاظ على قناعات راسخة في مواجهة عدو يستخدم الدعاية كأحد أنواع الأسلحة الرئيسية، ليست فقط فظة، بل وأحياناً ماكرة للغاية. وسيكون هذا غير كاف عندما نواجه، بعد النصر، الحاجة إلى مواجهة عواقب هذه الدعاية، والتي، بلا شك، ستشعر بها لفترة طويلة سواء في دول المحور نفسها أو في الدول الأخرى التي تقع تحت تأثيرها. وبهذه الطريقة، لن نتمكن من إقناع الآخرين بالقتال إلى جانبنا من منطلق التضامن مع مُثُلنا، ولن نتمكن من بناء عالم جديد بعد النصر، آمن وحر بشكل واضح.
وهذا أمر مؤسف، لكنه حقيقة: إن تجربة تفاعل البلدان الديمقراطية مع الأنظمة الديكتاتورية في فترة ما قبل الحرب، وكذلك محاولاتها اللاحقة للقيام بالدعاية الخاصة بها وصياغة أهداف الحرب، كشفت عن وجود خلل داخلي في العلاقات. الغموض وعدم اليقين بشأن أهدافهم الخاصة، والتي لا يمكن تفسيرها إلا من خلال عدم وضوح المثل العليا وسوء فهم طبيعة الاختلافات العميقة الموجودة بينهم وبين عدوهم. لقد ضللنا أنفسنا، لأننا كنا نؤمن بصدق تصريحات العدو من ناحية، ومن ناحية أخرى، رفضنا أن نصدق أن العدو صادق في اعترافه ببعض المعتقدات التي نعتنقها نحن أيضاً. ألم ينخدع حزبا اليسار واليمين بالاعتقاد بأن الاشتراكيين الوطنيين يدافعون عن الرأسمالية ويعارضون الاشتراكية بكل أشكالها؟ ألم يُعرض علينا عنصر أو آخر من عناصر النظام الهتلري كنموذج، كما لو أنهم لم يكونوا جزءًا لا يتجزأ من كل واحد ويمكن دمجهم بشكل آمن وغير مؤلم مع أشكال الحياة في مجتمع حر، حارس الحرية؟ الذي نود أن نقف؟ لقد ارتكبنا العديد من الأخطاء الخطيرة قبل وبعد بداية الحرب، وذلك ببساطة لأننا لم نفهم عدونا بشكل صحيح. ويبدو أننا ببساطة لا نريد أن نفهم كيف نشأت الشمولية، لأن هذا الفهم يهدد بتدمير بعض الأوهام العزيزة على قلوبنا.
لن نكون قادرين على التفاعل بنجاح مع الألمان حتى نفهم ما هي الأفكار التي تحركهم الآن وما هو أصل هذه الأفكار. الحجج حول الفساد الداخلي للألمان كأمة، والتي يمكن سماعها كثيرًا مؤخرًا، لا تصمد أمام النقد ولا تبدو مقنعة للغاية حتى بالنسبة لأولئك الذين طرحوها. ناهيك عن حقيقة أنهم يشوهون سمعة كوكبة كاملة من المفكرين الإنجليز الذين تحولوا باستمرار على مدار القرن الماضي إلى الفكر الألماني واستخلصوا منه الأفضل (وإن لم يكن الأفضل فقط). لنتذكر، على سبيل المثال، أنه عندما كتب جون ستيوارت ميل مقالته الرائعة "عن الحرية" قبل ثمانين عامًا، كان مستوحى في المقام الأول من أفكار اثنين من الألمان - جوته وويلهلم فون هومبولت. [بالنسبة لأولئك الذين يشككون في ذلك، يمكنني أن أوصي بالرجوع إلى شهادة اللورد مورلي، الذي يسميها في "مذكراته" "المقبولة عمومًا" أن "الأفكار الرئيسية لمقال "0 حرية" ليست أصلية، ولكنها جاءت إلينا" من ألمانيا." ومن ناحية أخرى، كان الرائدان الأكثر تأثيرًا لأفكار الاشتراكية الوطنية هما رجل اسكتلندي وإنجليزي - توماس كارليل وهيوستن ستيوارت تشامبرلين. باختصار، مثل هذه الحجج لا تنسب إلى مؤلفيها، لأنها، كما هو واضح، تمثل تعديلًا فظًا للغاية للنظريات العنصرية الألمانية.
المشكلة ليست في السبب الذي يجعل الألمان شرسين (ربما هم أنفسهم ليسوا أفضل أو أسوأ من الأمم الأخرى)، ولكن في ما هي الظروف التي اكتسبت بسببها بعض الأفكار قوة وأصبحت مهيمنة في المجتمع الألماني على مدى السنوات السبعين الماضية. ولماذا وصل بعض الأشخاص إلى السلطة في ألمانيا نتيجة لذلك. وإذا كنا نشعر بالكراهية لكل شيء ألماني، وليس لهذه الأفكار التي استحوذت على عقول الألمان اليوم، فمن غير المرجح أن نفهم من أي جانب يهددنا الخطر الحقيقي. غالبًا ما يكون مثل هذا الموقف مجرد محاولة للهروب من الواقع، وإغماض أعيننا عن العمليات التي لا تحدث بأي حال من الأحوال في ألمانيا وحدها، وهي محاولة تفسرها عدم الرغبة في إعادة النظر في الأفكار المستعارة من الألمان والمضللة. أقل من الألمان أنفسهم. إن تحويل النازية إلى فساد الأمة الألمانية أمر بالغ الخطورة، لأنه من السهل تحت هذه الذريعة أن تفرض علينا نفس المؤسسات التي تشكل السبب الحقيقي لهذا الفساد.
يختلف تفسير الأحداث في ألمانيا وإيطاليا المقدم في هذا الكتاب بشكل كبير عن وجهات النظر حول هذه الأحداث التي عبر عنها غالبية المراقبين الأجانب والمهاجرين السياسيين من هذه البلدان. وإذا كانت وجهة نظري صحيحة، فإنها ستفسر في الوقت نفسه لماذا لا يتمكن المهاجرون ومراسلو الصحف الإنجليزية والأمريكية، ومعظمهم من ذوي الآراء الاشتراكية، من رؤية هذه الأحداث في شكلها الحقيقي. إن النظرية السطحية وغير الصحيحة في نهاية المطاف، والتي تختزل الاشتراكية القومية إلى مجرد رد فعل تثيره بشكل متعمد مجموعات تعرضت امتيازاتها ومصالحها للتهديد بسبب تقدم الاشتراكية، تجد الدعم بين جميع الذين شاركوا في وقت ما بنشاط في الحركة الأيديولوجية التي انتهت بالنصر. من الاشتراكية القومية، ولكن في مرحلة ما دخل في صراع مع النازيين واضطر إلى مغادرة بلاده. لكن حقيقة أن هؤلاء الأشخاص شكلوا المعارضة المهمة الوحيدة للنازية تعني فقط أن جميع الألمان تقريبًا أصبحوا اشتراكيين، وأن الليبرالية بمفهومها الأصلي أفسحت المجال تمامًا للاشتراكية. سأحاول أن أبين أن الصراع بين القوى "اليسارية" والاشتراكيين الوطنيين "اليمينين" في ألمانيا هو صراع حتمي ينشأ دائما بين الفصائل الاشتراكية المتنافسة. وإذا كانت وجهة نظري صحيحة، فهذا يعني أن المهاجرين الاشتراكيين الذين يواصلون التمسك بقناعاتهم يساعدون في الواقع، ولو بنوايا حسنة، في وضع البلد الذي منحهم اللجوء على المسار الذي تجتازه ألمانيا.
أعلم أن العديد من أصدقائي الإنجليز يشعرون بالصدمة إزاء وجهات النظر شبه الفاشية التي يعبر عنها عادة اللاجئون الألمان، الذين يعتبرون بقناعاتهم اشتراكيين بلا شك. ويميل البريطانيون إلى تفسير ذلك بالأصل الألماني للمهاجرين، لكن السبب في الواقع هو وجهات نظرهم الاشتراكية. لقد أتيحت لهم ببساطة الفرصة للتقدم في تطوير وجهات نظرهم عدة خطوات أبعد من الاشتراكيين الإنجليز أو الأمريكيين. بالطبع، تلقى الاشتراكيون الألمان دعما كبيرا في وطنهم بسبب خصوصيات التقليد البروسي. إن القرابة الداخلية بين البروسية والاشتراكية، والتي كانت مصدرا للفخر الوطني في ألمانيا، تؤكد فقط فكرتي الرئيسية. [لا يمكن إنكار وجود صلة قرابة بين الاشتراكية وتنظيم الدولة البروسية. لقد تم الاعتراف به بالفعل من قبل الاشتراكيين الفرنسيين الأوائل. قبل وقت طويل من بدء فكرة إدارة بلد كامل على نموذج إدارة المصنع في إلهام الاشتراكيين في القرن التاسع عشر، اشتكى الشاعر البروسي نوفاليس من أنه "لم يتم حكم أي بلد على الإطلاق على نموذج المصنع مثل بروسيا بعد وفاة" فريدريك ويليام" (انظر نوفاليس
الطريق إلى العبودية
الاشتراكيون من كل الأحزاب
مقدمة
الحرية، مهما كانت، عادة ما تُفقد تدريجياً.
عندما يكتب عالم الاجتماع كتابا سياسيا، فمن واجبه أن يقول ذلك مباشرة. هذا كتاب سياسي، ولا أريد أن أدعي أنه يدور حول شيء آخر، على الرغم من أنني أستطيع أن أشير إلى نوعه بمصطلح أكثر دقة، على سبيل المثال، مقال اجتماعي فلسفي. ومع ذلك، مهما كان عنوان الكتاب، فإن كل ما أكتبه فيه ينبع من التزامي بقيم أساسية معينة. ويبدو لي أنني قمت بواجبي الآخر الذي لا يقل أهمية، حيث أوضحت بالكامل في الكتاب نفسه ما هي القيم التي تستند إليها جميع الأحكام الواردة فيه.
ويبقى أن أضيف أنه على الرغم من أن هذا كتاب سياسي، إلا أنني متأكد تمامًا من أن المعتقدات الواردة فيه ليست تعبيرًا عن اهتماماتي الشخصية. لا أرى أي سبب يجعل مجتمعًا من النوع الذي أفضّله بوضوح يمنحني أي امتيازات على غالبية زملائي المواطنين. وفي الواقع، كما يزعم زملائي الاشتراكيون، فإنني باعتباري خبيراً اقتصادياً سوف أحتل مكاناً أكثر بروزا في المجتمع الذي أعارضه (إذا كان بوسعي بطبيعة الحال أن أتقبل وجهات نظرهم). أنا واثق بنفس القدر من أن اختلافي مع هذه الآراء ليس نتيجة لتربيتي، لأنها هي التي التزمت بها في سن مبكرة وهي التي أجبرتني على تكريس نفسي للدراسات المهنية في الاقتصاد. بالنسبة لأولئك الذين، كما جرت العادة الآن، على استعداد لرؤية دوافع أنانية في أي عرض لموقف سياسي، اسمحوا لي أن أضيف أن لدي كل الأسباب لعدم كتابة هذا الكتاب أو نشره. ولا شك أن ذلك سيسيء إلى كثيرين ممن أود أن أبقى على علاقة ودية معهم. وبسببها، اضطررت إلى تأجيل أعمال أخرى، والتي أعتبرها بشكل عام أكثر أهمية وأشعر أنني مستعد لها بشكل أفضل. وأخيرًا، فإنه سيضر بإدراك نتائج أنشطتي البحثية، بالمعنى الصحيح، الذي أشعر بميل حقيقي إليه.
إذا كنت، على الرغم من ذلك، ما زلت أعتبر نشر هذا الكتاب واجبي، فقد كان ذلك فقط بسبب العواقب الغريبة والمحفوفة بالعواقب التي لا يمكن التنبؤ بها للوضع (الذي يصعب ملاحظته لعامة الناس) والذي تطور الآن في المناقشات حول السياسة الاقتصادية المستقبلية. والحقيقة أن أغلب الاقتصاديين انجذبوا مؤخراً إلى التطورات العسكرية وصمتوا بسبب الموقف الرسمي الذي يشغلونه. ونتيجة لذلك، فإن الرأي العام حول هذه القضايا اليوم يتشكل بشكل أساسي من قبل الهواة، أولئك الذين يحبون الصيد في المياه العكرة أو يبيعون علاجًا عالميًا لجميع الأمراض بسعر رخيص. في هذه الظروف، لا يحق لأي شخص لا يزال لديه الوقت للعمل الأدبي أن يحتفظ لنفسه بمخاوف من أن الكثيرين يتشاركون، ولكنهم لا يستطيعون التعبير، مع ملاحظة الاتجاهات الحديثة. وفي ظروف أخرى، أود بكل سرور أن أترك المناقشة حول السياسة الوطنية للأشخاص الأكثر موثوقية ومعرفة في هذا الشأن.
تم تلخيص الأحكام الرئيسية لهذا الكتاب لأول مرة في مقالة "الحرية والنظام الاقتصادي" التي نشرت في أبريل 1938 في مجلة "المراجعة المعاصرة"، وفي عام 1939 أعيد طبعها في نسخة موسعة في إحدى "الكتيبات الاجتماعية والسياسية"، والتي نشرت تحت تحرير البروفيسور. مطبعة جامعة شيكاغو جيدون. وأشكر ناشري هذين المنشورين على الإذن بإعادة طبع بعض المقتطفات منهما.
اف ايه حايك
مقدمة
أكثر ما يزعج فولتا هو تلك الدراسات التي تكشف عن نسب الأفكار.
اللورد إيكتون
تختلف الأحداث الحديثة عن الأحداث التاريخية في أننا لا نعرف إلى أين تقودنا. إذا نظرنا إلى الوراء، يمكننا أن نفهم الأحداث الماضية من خلال تتبع وتقييم عواقبها. لكن التاريخ الحالي ليس تاريخا بالنسبة لنا. إنه موجه نحو المجهول، ولا يمكننا أبدًا أن نقول ما ينتظرنا في المستقبل. سيكون كل شيء مختلفًا إذا أتيحت لنا الفرصة لعيش نفس الأحداث مرة أخرى، ومعرفة النتيجة مسبقًا. سننظر بعد ذلك إلى الأشياء بعيون مختلفة تمامًا، وفيما بالكاد نلاحظه الآن، سنرى نذيرًا للتغيرات المستقبلية. وربما يكون من الأفضل أن تكون هذه التجربة مغلقة أمام الإنسان، وأنه لا يعرف القوانين التي تحكم التاريخ.
ومع ذلك، على الرغم من أن التاريخ لا يكرر نفسه حرفيا، ومن ناحية أخرى، لا يوجد تطور للأحداث أمر لا مفر منه، يمكننا أن نتعلم من الماضي من أجل منع تكرار بعض العمليات. ليس من الضروري أن تكون نبيًا لتدرك الخطر الوشيك. في بعض الأحيان، يسمح الجمع بين الخبرة والاهتمام لشخص واحد فجأة برؤية الأشياء من زاوية لا يراها الآخرون بعد.
الصفحات التالية هي نتيجة تجربتي الشخصية. الحقيقة هي أنني تمكنت من عيش نفس الفترة مرتين، مرتين على الأقل لألاحظ تطورًا مشابهًا جدًا للأفكار. من غير المرجح أن تكون هذه التجربة متاحة لشخص يعيش طوال الوقت في بلد واحد، ولكن إذا كنت تعيش لفترة طويلة في بلدان مختلفة، فإنه في ظل ظروف معينة يتبين أنه يمكن تحقيقه. والحقيقة هي أن تفكير معظم الأمم المتحضرة يخضع أساسًا لنفس التأثيرات، لكنها تظهر في أوقات مختلفة وبسرعات مختلفة. ولذلك، عند الانتقال من بلد إلى آخر، يمكنك أحيانًا أن تشهد نفس المرحلة من التطور الفكري مرتين. وفي نفس الوقت تتكثف المشاعر بطريقة غريبة. عندما تسمع للمرة الثانية آراء أو نداءات سمعتها بالفعل منذ عشرين أو خمسة وعشرين عامًا، فإنها تكتسب معنى ثانيًا، ويُنظر إليها على أنها أعراض لاتجاه معين، كعلامات تشير، إن لم تكن الحتمية، ففي أي حال ، احتمال نفس الشيء. كأول مرة، تطور الأحداث.
ربما حان الوقت لقول الحقيقة، مهما بدت مريرة؛ والدولة التي نخاطر بتكرار مصيرها هي ألمانيا. صحيح أن الخطر لم يصل بعد إلى العتبة، وأن الوضع في إنجلترا والولايات المتحدة لا يزال بعيدًا تمامًا عما لاحظناه في السنوات الأخيرة في ألمانيا. ولكن، على الرغم من أنه لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه، يجب أن ندرك أنه مع كل خطوة نخطوها، ستكون العودة إلى الوراء أكثر صعوبة. وإذا كنا، إلى حد كبير، أسياد مصيرنا، فإننا في موقف معين نعمل كرهائن للأفكار التي أنشأناها بأنفسنا. ولن نتمكن من التغلب عليه إلا من خلال إدراك الخطر في الوقت المناسب.
إن إنجلترا والولايات المتحدة الحديثة ليستا مثل ألمانيا هتلر كما عرفناها خلال هذه الحرب. ولكن من غير المرجح أن يتجاهل أي شخص يبدأ في دراسة تاريخ الفكر الاجتماعي التشابه السطحي بأي حال من الأحوال بين تطور الأفكار الذي حدث في ألمانيا أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدها، والاتجاهات الحالية التي انتشرت في البلدان الديمقراطية. وهنا اليوم ينضج نفس التصميم على الحفاظ على الهياكل التنظيمية التي تم إنشاؤها في البلاد لأغراض دفاعية من أجل استخدامها لاحقًا في الإبداع السلمي. وهنا يتطور نفس الازدراء لليبرالية القرن التاسع عشر، ونفس "الواقعية" المنافقة، ونفس الاستعداد القدري لقبول "الاتجاهات الحتمية". وما لا يقل عن تسعة من كل عشرة دروس يحثنا الإصلاحيون الصاخبون على تعلمها من هذه الحرب هي بالضبط نفس الدروس التي تعلمها الألمان من الحرب الأخيرة والتي منها تم إنشاء النظام النازي. ستتاح لنا الفرصة أكثر من مرة في هذا الكتاب للتأكد من أننا نسير على خطى ألمانيا في العديد من النواحي الأخرى، متخلفة عنها بمقدار خمسة عشر إلى خمسة وعشرين عامًا. لا يحب الناس أن يتذكروا ذلك، ولكن لم تمر سنوات عديدة منذ أن نظر التقدميون إلى السياسات الاشتراكية في ألمانيا كمثال يحتذى به، تمامًا كما كانت كل أعين التقدميين في الآونة الأخيرة مركزة على السويد. وإذا تعمقنا في الماضي، فلا يسعنا إلا أن نتذكر مدى عمق تأثير السياسة والأيديولوجية الألمانية على المثل العليا لجيل كامل من البريطانيين والأمريكيين جزئيا عشية الحرب العالمية الأولى.
قضى المؤلف أكثر من نصف حياته البالغة في وطنه النمسا، على اتصال وثيق بالبيئة الفكرية الألمانية، والنصف الثاني في الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا. خلال هذه الفترة الثانية، نمت لديه تدريجيا قناعة بأن القوى التي دمرت الحرية في ألمانيا كانت تعمل هنا أيضا، جزئيا على الأقل، وكانت طبيعة الخطر ومصادره أقل فهما هنا مما كانت عليه في وقتهم في ألمانيا. وهنا لم يروا بعد المأساة التي وقعت في ألمانيا، حيث فتح أصحاب النوايا الطيبة، الذين يعتبرون نموذجاً ويثير الإعجاب في البلدان الديمقراطية، الطريق أمام قوى تجسد الآن كل ما نكرهه أكثر من أي شيء آخر. إن فرصنا في تجنب مثل هذا المصير تعتمد على رصانتنا، وعلى استعدادنا للتشكيك في الآمال والتطلعات التي نزرعها اليوم ورفضها إذا كانت تحتوي على خطر. وفي غضون ذلك، يشير كل شيء إلى أننا نفتقر إلى الشجاعة الفكرية اللازمة للاعتراف بأخطائنا. وما زلنا لا نريد أن نرى أن صعود الفاشية والنازية لم يكن رد فعل على الاتجاهات الاشتراكية في الفترة السابقة، بل كان استمرارًا وتطورًا حتميًا لهذه الاتجاهات. ولا يريد كثيرون الاعتراف بهذه الحقيقة حتى بعد أن أصبحت أوجه التشابه بين أسوأ تجليات النظام في روسيا الشيوعية وألمانيا الفاشية أكثر وضوحا. ونتيجة لذلك، فإن الكثيرين، الذين يرفضون النازية كأيديولوجية ولا يقبلون بصدق أيًا من مظاهرها، يسترشدون في أنشطتهم بالمثل العليا التي يفتح تنفيذها طريقًا مباشرًا إلى الاستبداد الذي يكرهونه.
الطريق إلى العبودية
© فريدريش أوغست فون هايك، 1944
© الترجمة. م.جنيدوفسكي، 2010
© الطبعة الروسية AST Publishers، 2010
مقدمة لطبعة 1976 طبعة
مع هذا الكتاب، الذي كتبته في وقت فراغي في الفترة 1940-1943، عندما كنت أعمل في الغالب على مشاكل النظرية الاقتصادية البحتة، وبشكل غير متوقع بالنسبة لي، بدأ عملي الذي يزيد عن ثلاثين عامًا في مجال جديد. كانت المحاولة الأولى لإيجاد اتجاه جديد مدفوعة بغضبي من التفسير الخاطئ تمامًا للحركة النازية في الدوائر "التقدمية" البريطانية. قادني هذا الانزعاج إلى كتابة مذكرة إلى مدير كلية لندن للاقتصاد آنذاك، السير ويليام بيفريدج، ثم مقالة للمجلة المعاصرة لعام 1938، والتي قمت، بناءً على طلب البروفيسور هاري د. جيديونز، بتوسيع نطاق نشرها. في منشوراته عن السياسة العامة والتي، على مضض كبير (اكتشفت أن جميع زملائي البريطانيين الأكثر كفاءة منشغلون بتقدم الأعمال العدائية) قمت أخيرًا بتحويلها إلى هذه الرسالة. على الرغم من النجاح غير المتوقع تمامًا لـ "الطريق إلى العبودية" (والطبعة الأمريكية المخطط لها في البداية كانت أكثر نجاحًا من النسخة البريطانية)، إلا أنني لم أكن راضيًا عنها لفترة طويلة. ورغم أن الكتاب يذكر بصراحة في البداية أن الأمر ذو طبيعة سياسية، إلا أن زملائي في العلوم الاجتماعية تمكنوا من غرس الشعور في داخلي بأنني كنت أفعل الشيء الخطأ، وأنا نفسي كنت في حيرة من أمري بشأن ما إذا كنت مؤهلاً بما يكفي لتجاوزه حدود الاقتصاد بالمعنى التقني للكلمة. لن أتحدث هنا عن الغضب الذي أثاره كتابي في بعض الدوائر، ولا عن الاختلاف الغريب بين استقباله في بريطانيا العظمى والولايات المتحدة - لقد كتبت عن هذا قبل عقدين من الزمن في "مقدمة للجيب الأمريكي الأول" الإصدار " ولإعطاء فكرة عن رد الفعل الشائع، سأذكر حادثة كتب فيها فيلسوف معروف، سيبقى اسمه مجهولا، إلى فيلسوف آخر رسالة يعاتبه فيها على مدحه هذا الكتاب الفاضح، الذي قاله نفسه "بالطبع لم يقرأ!" وعلى الرغم من أنني بذلت جهدًا كبيرًا للبقاء ضمن إطار الاقتصاد الصحيح، إلا أنني لم أستطع منع نفسي من التفكير في أن الأسئلة التي أثرتها بإهمال كانت أكثر تعقيدًا وأهمية من أسئلة النظرية الاقتصادية، وأن ما قيل في النسخة الأصلية من عملي كان ضروريًا. التوضيح والتهذيب . عندما كتبت هذا الكتاب، لم أكن بأي حال من الأحوال متحرراً بما فيه الكفاية من الأحكام المسبقة والأحكام المسبقة التي تحكم الرأي العام، بل وأقل قدرة على تجنب الخلط المعتاد بين المصطلحات والمفاهيم - وهو الأمر الذي بدأت بعد ذلك في توخي الحذر الشديد تجاهه. بطبيعة الحال، لا يمكن للمناقشة التي أجريتها حول العواقب المترتبة على السياسة الاجتماعية أن تكتمل دون النظر بشكل كاف في متطلبات وإمكانيات نظام السوق المنظم بشكل صحيح. وهذه هي المشكلة الأخيرة التي خصصت لها دراساتي الإضافية في هذا المجال. كانت النتيجة الأولى لجهودي لشرح نظام الحرية هي دراسة رئيسية، "دستور الحرية" (1960)، والتي حاولت فيها إعادة صياغة جوهرية والتعبير بشكل أكثر تماسكًا عن المذاهب الكلاسيكية لليبرالية القرن التاسع عشر. إن إدراك أن إعادة الصياغة هذه تركت عددًا من الأسئلة المهمة دون إجابة دفعني إلى تقديم إجاباتي الخاصة عليها في كتاب "القانون والتشريع والحرية" المكون من ثلاثة مجلدات، والذي نُشر المجلد الأول منه عام 1973.
يبدو لي أنني تمكنت خلال العشرين عامًا الماضية من تعلم الكثير عن المشكلات التي أثيرت في هذا الكتاب، على الرغم من أنني خلال هذا الوقت لا أعتقد أنني أعدت قراءته مرة أخرى. عندما أعدت قراءته الآن لكتابة هذه المقدمة، شعرت لأول مرة أنني لم أكن أشعر بالخجل منه فحسب، بل على العكس من ذلك، فخور به - ليس أقله الاكتشافات التي سمحت لي بإهداءه إلى "الاشتراكيين". من جميع الأطراف." في الواقع، على الرغم من أنني قرأت خلال هذا الوقت الكثير من الأشياء التي لم أكن أعرفها عندما كتبتها، إلا أنني الآن أتفاجأ كثيرًا بمدى تأكيد ما فهمته في ذلك الوقت، في بداية رحلتي، من خلال المزيد من البحث. . وعلى الرغم من أن أعمالي اللاحقة، كما آمل، ستكون أكثر فائدة للمحترفين، إلا أنني على استعداد دون تردد للتوصية بهذا الكتاب القديم للقارئ العام الذي يريد مقدمة بسيطة وغير مثقلة بالتفاصيل الفنية لمشكلة، في رأيي. ، لا تزال واحدة من أكثر القضايا إلحاحا ولا تزال تنتظر قرارها.
ربما يتساءل القارئ عما إذا كان هذا يعني أنني ما زلت مستعدًا للدفاع عن جميع الاستنتاجات الرئيسية لهذا الكتاب، وستكون الإجابة على ذلك إيجابية بشكل عام. التحذير الأكثر أهمية الذي يجب القيام به هو أن المصطلحات قد تغيرت بمرور الوقت، وبالتالي قد يساء فهم الكثير مما يقال هنا. في الوقت الذي كتبت فيه "الطريق إلى العبودية"، كان مفهوماً الاشتراكية بوضوح على أنها تأميم وسائل الإنتاج والتخطيط الاقتصادي المركزي الذي يجعل التأميم ممكناً وضرورياً. وبهذا المعنى فإن السويد اليوم، على سبيل المثال، تتمتع بتنظيم أقل اشتراكياً من بريطانيا العظمى أو النمسا، على الرغم من أنه من المقبول عموماً أن السويد دولة أكثر اشتراكية. حدث هذا لأن الاشتراكية بدأت تُفهم في المقام الأول على أنها إعادة توزيع واسعة للدخل من خلال الضرائب ومؤسسات "دولة الرفاهية". في ظل هذا النوع من الاشتراكية، فإن الظواهر التي نوقشت في هذا الكتاب تحدث بشكل أبطأ، وليست واضحة، ولا يتم التعبير عنها بشكل كامل. أعتقد أن هذا سيؤدي في النهاية إلى نفس النتائج، على الرغم من أن العمليات نفسها لن تكون هي نفسها تمامًا كما هو موضح في كتابي.
غالبًا ما يُنسب لي الفضل في الاستنتاج القائل بأن أي تحرك نحو الاشتراكية يؤدي بالضرورة إلى الشمولية. ورغم وجود هذا الخطر، فإن هذا ليس هدف الكتاب. ونقطة أساسها هي أننا إذا لم نعيد النظر في مبادئ سياستنا، فسوف نواجه أسوأ العواقب، والتي لم تكن على الإطلاق هدف معظم مؤيدي هذه السياسة.
ويبدو لي اليوم أنني كنت مخطئًا في التقليل من شأن تجربة الشيوعية في روسيا. ربما يمكن التسامح مع هذا العيب، نظرًا لأنه في تلك السنوات التي كتبت فيها هذا، كانت روسيا حليفتنا في الحرب، ولم أكن قد تخلصت تمامًا بعد من التحيزات التدخلية المعتادة في ذلك الوقت، وبالتالي سمحت لنفسي بتقديم العديد من التنازلات - في رأيي اليوم غير مبرر. ومن المؤكد أنني لم أدرك تمامًا مدى سوء الأمور في العديد من النواحي. على سبيل المثال، فكرت في السؤال الذي طرحته على ص. 98: إذا “حصل هتلر على سلطة غير محدودة من خلال وسائل دستورية بحتة<…>هل يجرؤ أحد على التأكيد على هذا الأساس أن سيادة القانون لا تزال موجودة في ألمانيا؟ ومع ذلك، فقد اكتشف لاحقًا أن هذا هو بالضبط ما جادل به البروفيسوران هانز كيلسن وهارولد ج. لاسكي، وبعد هؤلاء المؤلفين المؤثرين، فقهاء اشتراكيون وعلماء سياسة آخرون. وأيًا كان الأمر، فإن المزيد من الاستكشاف للحركات الفكرية الحديثة والمؤسسات الحديثة لم يؤدي إلا إلى زيادة مخاوفي وقلقي. وقد تزايد تأثير الأفكار الاشتراكية، إلى جانب الإيمان الساذج بالنوايا الطيبة لأولئك الذين تتركز السلطة الشمولية في أيديهم، بشكل ملحوظ منذ أن كتبت "الطريق إلى العبودية".
لقد شعرت بالانزعاج لفترة طويلة لأن العمل، الذي كنت أعتبره كتيبًا عن موضوع اليوم، كان معروفًا على نطاق أوسع من أعمالي العلمية الفعلية. لكن بالنظر إلى ما كتبته من منظور الدراسات الإضافية حول القضايا المطروحة منذ أكثر من ثلاثين عامًا، لم أعد أشعر بالانزعاج. ورغم أن هناك الكثير في هذا الكتاب لم أتمكن من إثباته بشكل مقنع، إلا أنه كان محاولة صادقة للعثور على الحقيقة، وأعتقد أنني توصلت إلى بعض الاكتشافات التي ستفيد حتى أولئك الذين يختلفون معي وتساعدهم على تجنب المخاطر الجسيمة. .
الطريق إلى العبودية للكاتب فريدريش فون هايك هو أشهر كتاب ألفه الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1974. تُرجم العمل إلى أكثر من 20 لغة ويعتبر أحد الأعمال الأساسية لليبرالية الكلاسيكية. كان للكتاب تأثير كبير على السياسة والاقتصاد العالميين الحديثين، وأصبح الأساس لأفكار التخلي عن التنظيم الحكومي، وحفز العودة إلى النموذج الكلاسيكي للسوق التنافسية في المملكة المتحدة في عهد رونالد ريغان وفي الولايات المتحدة الأمريكية.
الفكرة الرئيسية
الفكرة الأساسية في كتاب "الطريق إلى العبودية" للكاتب فريدريش فون هايك هي أن التنظيم المخطط للاقتصاد يؤدي بشكل لا رجعة فيه إلى نمو الأيديولوجية الاشتراكية. وهذه بدورها هي الخطوة الأولى المهمة نحو الشمولية.
وفقا لهايك نفسه، وصلت النازية والفاشية إلى ذروتها، ولم تصبح رد فعل على الاتجاهات الاشتراكية، ولكن تطورها الحتمي.
كان الفيلسوف والاقتصادي النمساوي مقتنعا بأن رفض الحريات الاقتصادية لصالح التخطيط المركزي والجماعية يؤدي إلى حرمان المواطنين ليس فقط من الحريات الاقتصادية، ولكن أيضا من الحريات الإنسانية الأساسية. وهذا ما أسماه "الطريق إلى العبودية".
لغة هذا الكتاب، على الرغم من محتواه العميق والمعقد، بسيطة قدر الإمكان، مما جعل من الممكن ترجمته إلى عدة عشرات من اللغات، ويمكن لسكان الكوكب بأكمله التعرف على الأفكار المقدمة فيه.

يبدأ الكتاب بفصل "الطريق المرفوض" الذي يقدم فيه حايك تفسيره للأحداث التاريخية الأخيرة. تم نشر الطريق إلى العبودية في عام 1944، بينما كانت الحرب العالمية تقترب من نهايتها. ويشير الإيكونوميست إلى أن هذه الحرب لم تكن مجرد صراع عسكري انخرطت فيه جميع الدول الأوروبية تقريبًا، بل كانت أيضًا صراعًا أيديولوجيًا حدث في إطار الحضارة الأوروبية.
في كتابه الطريق إلى العبودية، يجادل فريدريش فون هايك بأن إنكار الحريات الاقتصادية هو الذي يؤدي إلى تشكيل الشمولية. بحلول نهاية القرن التاسع عشر، كانت الثقة في كل شيء في جميع أنحاء العالم تتراجع، بسبب الرغبة في التغيير السريع، والرغبة في تدمير العالم القديم لبناء عالم جديد.
في فصل "اليوتوبيا الكبرى"، يصف المؤلف كيف، تحت راية الحرية، يتم استبدال الليبرالية بالاشتراكية في العالم. كانت الاشتراكية، التي اعتبرها هايك في البداية حركة شمولية، هي المحاولة الأخيرة التي قام بها قادة الثورة الفرنسية لإنجازها حتى نهايتها من خلال إعادة تنظيم "السلطة الروحية" وتأسيسها بشكل متعمد.
ينقسم كتاب "الطريق إلى العبودية" لفريدريش فون هايك إلى 15 فصلاً، يحتوي كل منها على بيان أساسي. في فصل "الفردية والجماعية"، يشير المؤلف إلى أن المشكلة الرئيسية للاشتراكيين هي إيمانهم بشيئين غير متوافقين - التنظيم والحرية. المصطلح نفسه يعني الحماية الاجتماعية للسكان والمساواة والعدالة الشاملة. ولكن لتحقيق هذا المثل الأعلى، يتم تطبيق مبادئ الاقتصاد المخطط.
تفترض الليبرالية تجنب الاحتكارات إلى أقصى حد، وإنشاء إطار تشريعي قوي، ومكافحة الفساد والاحتيال والجهل وسوء الاستخدام.
وبحسب هايك، فإن كراهية المنافسة بأي شكل من الأشكال أصبحت شائعة لدى جميع الاشتراكيين.
تخطيط لا مفر منه
"هل التخطيط أمر لا مفر منه؟" - هذا هو السؤال الذي يطرحه المؤلف في عنوان الفصل الرابع. يحاول هايك، في كتابه الطريق إلى العبودية، أن يفكك بالتفصيل الادعاء القائل بأنه بسبب تطور التكنولوجيا، تم احتكار السوق في نهاية المطاف.
إحدى الحجج الرئيسية للحاجة إلى التخطيط هي أنه بسبب الاحتكارات، لا يوجد سوى خيارين: إما نقل السيطرة على الإنتاج إلى الحكومة، أو البدء في السيطرة على الاحتكارات الخاصة.
وفقا لهايك، تنشأ الاحتكارات في أغلب الأحيان نتيجة لاتفاقيات سرية والدعم المباشر من كبار المسؤولين الحكوميين، وليس نتيجة لأي تنمية اقتصادية. ومن خلال إزالة هذه العقبة، يمكن تهيئة الظروف المثالية لتحفيز المنافسة.
في كتابه "الطريق إلى العبودية"، كتب فريدريش أوغست فون هايك أن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو اللامركزية. ويجب إلغاء السيطرة المباشرة لصالح التنسيق. على الأكثر، يمكن أن يكون هذا نظامًا من التدابير الضرورية لتنسيق تصرفات المشاركين الآخرين في السوق.
في فصل "التخطيط والديمقراطية"، يشير هايك إلى أن الشيوعية والأنظمة الجماعية والفاشية تختلف فقط في أهدافها النهائية. والقاسم المشترك بينهم هو التنظيم الواعي للقوى المنتجة المصممة لأداء مهمة محددة. عند البدء في بناء عملك وفق خطة محددة، من المهم التمييز بين احتياجات كل فرد، وإدخالها في نظام واحد من القيم، والذي يخضع لفكرة الدولة.
في كتابه "الطريق إلى العبودية"، يؤكد فريدريش هايك أن الحرية لا يتم تدميرها من خلال الدكتاتورية نفسها، ولكن من خلال التخطيط، الذي يؤدي حتما إلى الدكتاتورية، لأنه يصبح أداة ضرورية في مجتمع التخطيط على نطاق واسع.
"الخطة والقانون"

ويخصص فصل "الخطة والقانون" للاختلافات الموجودة بين ما يسمى "قواعد الأسس الموضوعية" التي تعتمدها سلطات التخطيط والقانون الرسمي. الفرق بينهما هو نفسه تمامًا كما هو الحال في قواعد الطريق والأوامر حول الطريقة التي يجب التحرك بها بعد ذلك.
في النسخة الأولى، لا تتعلق بأشخاص وأهداف محددة، لكنها في الثانية تستهدف أفرادًا محددين، وتحثهم على العمل من أجل هدف معين.
في كتابه "الطريق إلى العبودية"، يؤكد فون هايك أنه من أجل السيطرة على أمم بأكملها، هناك حاجة إلى مجموعة من الخبراء أو شخصية من نوع ما من القائد الأعلى، الذي في يديه كل السلطات غير المرتبطة بالإجراءات الديمقراطية. وقد توصل إلى هذه النتيجة في فصل “السيطرة الاقتصادية والشمولية”.
وهو يعرّف فقدان حرية الاختيار بأنه المواقف التي يبدأ فيها المواطنون، بدلاً من المكافآت المالية المحددة، في الحصول على المناصب العامة والتمييزات والامتيازات. تجد الحياة الاقتصادية نفسها تحت السيطرة الكاملة، حيث يفقد الإنسان فرصة اتخاذ ولو خطوة دون الإعلان علناً عن أهدافه ونواياه. كل حياة الإنسان تحت السيطرة. نفس الصورة كما في "الطريق إلى العبودية" لـ F. Hayek سيصفها أورويل بعد بضع سنوات في رواية "1984".
"من سيفوز؟"

جوهر الفصل "من يفوز؟" هو أن المجتمع، بعد أن فقد الملكية الخاصة، محروم من الحرية. وفي الوقت نفسه، تنتهي الموارد الحقيقية في أيدي الدولة أو بعض الهياكل المؤثرة.
ويشير المؤلف إلى أن تخطيط إنتاج الدولة يؤدي في النهاية إلى السيطرة الكاملة على الموارد المنتجة، وهذا يحد بشكل كبير من علاقات السوق. وعندما تصل إلى نقطة حرجة، يصبح من الضروري نشرها حتى تصبح شاملة.
كل هذا يؤدي إلى فقدان الفرد لوظيفته، ويصبح معتمدا على قرارات السلطات التي تحدد له مكانه في المجتمع وأين سيعمل وكيف يعيش. عندما تتولى الدولة مثل هذه الوظائف، يظل الشكل الحقيقي الوحيد للسلطة هو سلطة المسؤولين أو البيروقراطيين، أي أولئك الأشخاص الذين يسيطرون على الجهاز القسري.
"الحرية والأمن"
في هذا الفصل من كتاب الطريق إلى العبودية، يسهب هايك في الحديث عن مشكلة الانضباط التي تنشأ حتماً عندما تكون الدولة منخرطة في التخطيط لأمة بأكملها.
يصف المؤلف الجيش بأنه مؤسسة اجتماعية توضح المجتمع المخطط. يتم تحديد الموظفين ومسؤولياتهم من خلال الأمر، وإذا كان هناك نقص في الموارد، ينتهي الأمر بالجميع إلى اتباع نظام غذائي جوعًا. والأمن الاقتصادي في هذا النظام مكفول حصرا للعسكريين، لكنه يرتبط بفقدان الحرية الشخصية.
"لماذا يأتي الأسوأ إلى السلطة؟"

إن الجزء من كتاب "الطريق إلى العبودية" الذي يرد ملخص له في هذا المقال بعنوان هذا السؤال البلاغي قد أثار الاهتمام الأكبر بين القراء.
ويحاول في هذا الفصل تناول التأكيد على أن الشمولية ليست سيئة في حد ذاتها، ولكنها تفسدها الشخصيات التاريخية التي تجد نفسها في موقع المسؤولية. ويقنع المؤلف في أدلته وتأملاته القارئ بأن هذا الشكل من السلطة لا يتوافق مع القيم الفردية المتأصلة في الحضارات الغربية.
إذا تم وضع الدولة أو المجتمع فوق الفرد، فإن أولئك الذين تتطابق مصالحهم مع الجماعة هم وحدهم الذين يبقون أعضائها الحقيقيين. الشرط الأساسي لبقاء الديكتاتور في السلطة هو البحث عن عدو (داخلي أو خارجي) ومحاربته بلا رحمة.
حيثما يوجد هدف أسمى، حيث يعتقد أن كل الوسائل صالحة لتحقيقه، لا تبقى قواعد ومعايير أخلاقية. والقسوة من أجل أداء الواجب أمر مبرر؛ فالجماعيون يعتبرون قيم الفرد وحقوقه عائقًا أمام تحقيق النتيجة النهائية. كونهم مخلصين لمثلهم الأعلى، فإنهم على استعداد لارتكاب حتى الأفعال غير الأخلاقية والدنيئة. عندما يتم تأسيس القيم نفسها من قبل القائد، يتحرر مرؤوسوه من القناعات الأخلاقية. الشيء الوحيد المطلوب منهم هو الطاعة دون أدنى شك.
لم يعودوا خائفين من العمل القذر؛ يصبح إكمال هذه المهام بمثابة تذكرة إلى أعلى السلم الوظيفي، إلى السلطة الحقيقية. الأشخاص الذين يحتفظون بالمثل الداخلية يرفضون تنفيذها؛ فقط الأشخاص الأكثر افتقارًا إلى المبادئ سيفعلون ذلك.
يشير حايك إلى منظمات مثل SD وSS، ووزارة الدعاية والجستابو في الرايخ الثالث، بالإضافة إلى خدمات مماثلة في إيطاليا، حيث يُطلب من الموظفين في المقام الأول أن يكونوا قاسيين، والقدرة على التخويف والمراقبة والخداع.
"نهاية الحقيقة"
في فصل "نهاية الحقيقة"، يكتب هايك أن الإكراه لا يكفي لخدمة هدف واحد. ومن الضروري أن يؤمن الناس بأهمية وضرورة هذا الهدف. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الدعاية. من الضروري استبدال المفاهيم، لأنه عليك أن تقنع ليس فقط بأهمية الهدف نفسه، ولكن أيضًا بطرق تحقيقه.
يمكن أن يتغير معنى الكلمات في سياق الدعاية الحكومية اعتمادًا على الظروف الخارجية أو الداخلية. يتم قمع الانتقادات والشكوك. يتم فرض السيطرة الكاملة على المعلومات، مما يؤثر حتى على المناطق غير السياسية تماما.
جذور النازية

يقدم هايك مفهوم الجذور الاشتراكية للنازية، موضحًا مدى قرب هذه المذاهب من بعضها البعض.
على سبيل المثال، يستشهد بعبارات وأعمال العديد من القادة الاشتراكيين الوطنيين الذين بدأوا حياتهم السياسية كماركسيين.
الأهداف المثالية

يرى هايك أن الناس في المجتمع الحديث غالبًا ما يرفضون الانصياع لقوانين السوق. بل إنه على استعداد للتضحية بحرياته فقط من أجل الحصول على الأمن الاقتصادي الفعال.
كل هذا يؤدي إلى إجراءات قصيرة النظر لا تجلب إلا الضرر وتؤدي إلى الشمولية.
"كيف سيكون شكل العالم بعد الحرب؟"
وهذا هو عنوان الفصل الأخير من هذا الكتاب. عشية النهاية القادمة للحرب العالمية، يشير المؤلف إلى عدم مقبولية تشكيل هيئات التخطيط فوق الوطنية.
ووفقا للفيلسوف، يمكن أن يصبح الحكم الدولي نموذجا أوليا للديكتاتورية الصريحة، التي تجسد أفكار الاشتراكية القومية على نطاق أوسع. وهذا النموذج سيؤدي إلى التوتر العالمي. والشيء الرئيسي هو منع الدول المتقدمة من البدء في فرض أفكارها الأخلاقية بالقوة على الآخرين. ويخلص المؤلف إلى أنهم في هذه الحالة، يخاطرون بأن يجدوا أنفسهم في موقف يتعين عليهم فيه اتخاذ قرار بشأن الأفعال غير الأخلاقية.
الطريق إلى العبودية
الاشتراكيون من كل الأحزاب
مقدمة
الحرية، مهما كانت، عادة ما تُفقد تدريجياً.
ديفيد هيوم
عندما يكتب عالم الاجتماع كتابا سياسيا، فمن واجبه أن يقول ذلك مباشرة. هذا كتاب سياسي، ولا أريد أن أدعي أنه يدور حول شيء آخر، على الرغم من أنني أستطيع أن أشير إلى نوعه بمصطلح أكثر دقة، على سبيل المثال، مقال اجتماعي فلسفي. ومع ذلك، مهما كان عنوان الكتاب، فإن كل ما أكتبه فيه ينبع من التزامي بقيم أساسية معينة. ويبدو لي أنني قمت بواجبي الآخر الذي لا يقل أهمية، حيث أوضحت بالكامل في الكتاب نفسه ما هي القيم التي تستند إليها جميع الأحكام الواردة فيه.
ويبقى أن أضيف أنه على الرغم من أن هذا كتاب سياسي، إلا أنني متأكد تمامًا من أن المعتقدات الواردة فيه ليست تعبيرًا عن اهتماماتي الشخصية. لا أرى أي سبب يجعل مجتمعًا من النوع الذي أفضّله بوضوح يمنحني أي امتيازات على غالبية زملائي المواطنين. وفي الواقع، كما يزعم زملائي الاشتراكيون، فإنني باعتباري خبيراً اقتصادياً سوف أحتل مكاناً أكثر بروزا في المجتمع الذي أعارضه (إذا كان بوسعي بطبيعة الحال أن أتقبل وجهات نظرهم). أنا واثق بنفس القدر من أن اختلافي مع هذه الآراء ليس نتيجة لتربيتي، لأنها هي التي التزمت بها في سن مبكرة وهي التي أجبرتني على تكريس نفسي للدراسات المهنية في الاقتصاد. بالنسبة لأولئك الذين، كما جرت العادة الآن، على استعداد لرؤية دوافع أنانية في أي عرض لموقف سياسي، اسمحوا لي أن أضيف أن لدي كل الأسباب لعدم كتابة هذا الكتاب أو نشره. ولا شك أن ذلك سيسيء إلى كثيرين ممن أود أن أبقى على علاقة ودية معهم. وبسببها، اضطررت إلى تأجيل أعمال أخرى، والتي أعتبرها بشكل عام أكثر أهمية وأشعر أنني مستعد لها بشكل أفضل. وأخيرًا، فإنه سيضر بإدراك نتائج أنشطتي البحثية، بالمعنى الصحيح، الذي أشعر بميل حقيقي إليه.
إذا كنت، على الرغم من ذلك، ما زلت أعتبر نشر هذا الكتاب واجبي، فقد كان ذلك فقط بسبب العواقب الغريبة والمحفوفة بالعواقب التي لا يمكن التنبؤ بها للوضع (الذي يصعب ملاحظته لعامة الناس) والذي تطور الآن في المناقشات حول السياسة الاقتصادية المستقبلية. والحقيقة أن أغلب الاقتصاديين انجذبوا مؤخراً إلى التطورات العسكرية وصمتوا بسبب الموقف الرسمي الذي يشغلونه. ونتيجة لذلك، فإن الرأي العام حول هذه القضايا اليوم يتشكل بشكل أساسي من قبل الهواة، أولئك الذين يحبون الصيد في المياه العكرة أو يبيعون علاجًا عالميًا لجميع الأمراض بسعر رخيص. في هذه الظروف، لا يحق لأي شخص لا يزال لديه الوقت للعمل الأدبي أن يحتفظ لنفسه بمخاوف من أن الكثيرين يتشاركون، ولكنهم لا يستطيعون التعبير، مع ملاحظة الاتجاهات الحديثة. وفي ظروف أخرى، أود بكل سرور أن أترك المناقشة حول السياسة الوطنية للأشخاص الأكثر موثوقية ومعرفة في هذا الشأن.
تم تلخيص الأحكام الرئيسية لهذا الكتاب لأول مرة في مقالة "الحرية والنظام الاقتصادي" التي نشرت في أبريل 1938 في مجلة "المراجعة المعاصرة"، وفي عام 1939 أعيد طبعها في نسخة موسعة في إحدى "الكتيبات الاجتماعية والسياسية"، والتي نشرت تحت تحرير البروفيسور. مطبعة جامعة شيكاغو جيدون. وأشكر ناشري هذين المنشورين على الإذن بإعادة طبع بعض المقتطفات منهما.
اف ايه حايك
مقدمة
أكثر ما يزعج فولتا هو تلك الدراسات التي تكشف عن نسب الأفكار.
اللورد إيكتون
تختلف الأحداث الحديثة عن الأحداث التاريخية في أننا لا نعرف إلى أين تقودنا. إذا نظرنا إلى الوراء، يمكننا أن نفهم الأحداث الماضية من خلال تتبع وتقييم عواقبها. لكن التاريخ الحالي ليس تاريخا بالنسبة لنا. إنه موجه نحو المجهول، ولا يمكننا أبدًا أن نقول ما ينتظرنا في المستقبل. سيكون كل شيء مختلفًا إذا أتيحت لنا الفرصة لعيش نفس الأحداث مرة أخرى، ومعرفة النتيجة مسبقًا. سننظر بعد ذلك إلى الأشياء بعيون مختلفة تمامًا، وفيما بالكاد نلاحظه الآن، سنرى نذيرًا للتغيرات المستقبلية. وربما يكون من الأفضل أن تكون هذه التجربة مغلقة أمام الإنسان، وأنه لا يعرف القوانين التي تحكم التاريخ.
ومع ذلك، على الرغم من أن التاريخ لا يكرر نفسه حرفيا، ومن ناحية أخرى، لا يوجد تطور للأحداث أمر لا مفر منه، يمكننا أن نتعلم من الماضي من أجل منع تكرار بعض العمليات. ليس من الضروري أن تكون نبيًا لتدرك الخطر الوشيك. في بعض الأحيان، يسمح الجمع بين الخبرة والاهتمام لشخص واحد فجأة برؤية الأشياء من زاوية لا يراها الآخرون بعد.
الصفحات التالية هي نتيجة تجربتي الشخصية. الحقيقة هي أنني تمكنت من عيش نفس الفترة مرتين، مرتين على الأقل لألاحظ تطورًا مشابهًا جدًا للأفكار. من غير المرجح أن تكون هذه التجربة متاحة لشخص يعيش طوال الوقت في بلد واحد، ولكن إذا كنت تعيش لفترة طويلة في بلدان مختلفة، فإنه في ظل ظروف معينة يتبين أنه يمكن تحقيقه. والحقيقة هي أن تفكير معظم الأمم المتحضرة يخضع أساسًا لنفس التأثيرات، لكنها تظهر في أوقات مختلفة وبسرعات مختلفة. ولذلك، عند الانتقال من بلد إلى آخر، يمكنك أحيانًا أن تشهد نفس المرحلة من التطور الفكري مرتين. وفي نفس الوقت تتكثف المشاعر بطريقة غريبة. عندما تسمع للمرة الثانية آراء أو نداءات سمعتها بالفعل منذ عشرين أو خمسة وعشرين عامًا، فإنها تكتسب معنى ثانيًا، ويُنظر إليها على أنها أعراض لاتجاه معين، كعلامات تشير، إن لم تكن الحتمية، ففي أي حال ، احتمال نفس الشيء. كأول مرة، تطور الأحداث.
ربما حان الوقت لقول الحقيقة، مهما بدت مريرة؛ والدولة التي نخاطر بتكرار مصيرها هي ألمانيا. صحيح أن الخطر لم يصل بعد إلى العتبة، وأن الوضع في إنجلترا والولايات المتحدة لا يزال بعيدًا تمامًا عما لاحظناه في السنوات الأخيرة في ألمانيا. ولكن، على الرغم من أنه لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه، يجب أن ندرك أنه مع كل خطوة نخطوها، ستكون العودة إلى الوراء أكثر صعوبة. وإذا كنا، إلى حد كبير، أسياد مصيرنا، فإننا في موقف معين نعمل كرهائن للأفكار التي أنشأناها بأنفسنا. ولن نتمكن من التغلب عليه إلا من خلال إدراك الخطر في الوقت المناسب.
إن إنجلترا والولايات المتحدة الحديثة ليستا مثل ألمانيا هتلر كما عرفناها خلال هذه الحرب. ولكن من غير المرجح أن يتجاهل أي شخص يبدأ في دراسة تاريخ الفكر الاجتماعي التشابه السطحي بأي حال من الأحوال بين تطور الأفكار الذي حدث في ألمانيا أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدها، والاتجاهات الحالية التي انتشرت في البلدان الديمقراطية. وهنا اليوم ينضج نفس التصميم على الحفاظ على الهياكل التنظيمية التي تم إنشاؤها في البلاد لأغراض دفاعية من أجل استخدامها لاحقًا في الإبداع السلمي. وهنا يتطور نفس الازدراء لليبرالية القرن التاسع عشر، ونفس "الواقعية" المنافقة، ونفس الاستعداد القدري لقبول "الاتجاهات الحتمية". وما لا يقل عن تسعة من كل عشرة دروس يحثنا الإصلاحيون الصاخبون على تعلمها من هذه الحرب هي بالضبط نفس الدروس التي تعلمها الألمان من الحرب الأخيرة والتي منها تم إنشاء النظام النازي. ستتاح لنا الفرصة أكثر من مرة في هذا الكتاب للتأكد من أننا نسير على خطى ألمانيا في العديد من النواحي الأخرى، متخلفة عنها بمقدار خمسة عشر إلى خمسة وعشرين عامًا. لا يحب الناس أن يتذكروا ذلك، ولكن لم تمر سنوات عديدة منذ أن نظر التقدميون إلى السياسات الاشتراكية في ألمانيا كمثال يحتذى به، تمامًا كما كانت كل أعين التقدميين في الآونة الأخيرة مركزة على السويد. وإذا تعمقنا في الماضي، فلا يسعنا إلا أن نتذكر مدى عمق تأثير السياسة والأيديولوجية الألمانية على المثل العليا لجيل كامل من البريطانيين والأمريكيين جزئيا عشية الحرب العالمية الأولى.
قضى المؤلف أكثر من نصف حياته البالغة في وطنه النمسا، على اتصال وثيق بالبيئة الفكرية الألمانية، والنصف الثاني في الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا. خلال هذه الفترة الثانية، نمت لديه تدريجيا قناعة بأن القوى التي دمرت الحرية في ألمانيا كانت تعمل هنا أيضا، جزئيا على الأقل، وكانت طبيعة الخطر ومصادره أقل فهما هنا مما كانت عليه في وقتهم في ألمانيا. وهنا لم يروا بعد المأساة التي وقعت في ألمانيا، حيث فتح أصحاب النوايا الطيبة، الذين يعتبرون نموذجاً ويثير الإعجاب في البلدان الديمقراطية، الطريق أمام قوى تجسد الآن كل ما نكرهه أكثر من أي شيء آخر. إن فرصنا في تجنب مثل هذا المصير تعتمد على رصانتنا، وعلى استعدادنا للتشكيك في الآمال والتطلعات التي نزرعها اليوم ورفضها إذا كانت تحتوي على خطر. وفي غضون ذلك، يشير كل شيء إلى أننا نفتقر إلى الشجاعة الفكرية اللازمة للاعتراف بأخطائنا. وما زلنا لا نريد أن نرى أن صعود الفاشية والنازية لم يكن رد فعل على الاتجاهات الاشتراكية في الفترة السابقة، بل كان استمرارًا وتطورًا حتميًا لهذه الاتجاهات. ولا يريد كثيرون الاعتراف بهذه الحقيقة حتى بعد أن أصبحت أوجه التشابه بين أسوأ تجليات النظام في روسيا الشيوعية وألمانيا الفاشية أكثر وضوحا. ونتيجة لذلك، فإن الكثيرين، الذين يرفضون النازية كأيديولوجية ولا يقبلون بصدق أيًا من مظاهرها، يسترشدون في أنشطتهم بالمثل العليا التي يفتح تنفيذها طريقًا مباشرًا إلى الاستبداد الذي يكرهونه.